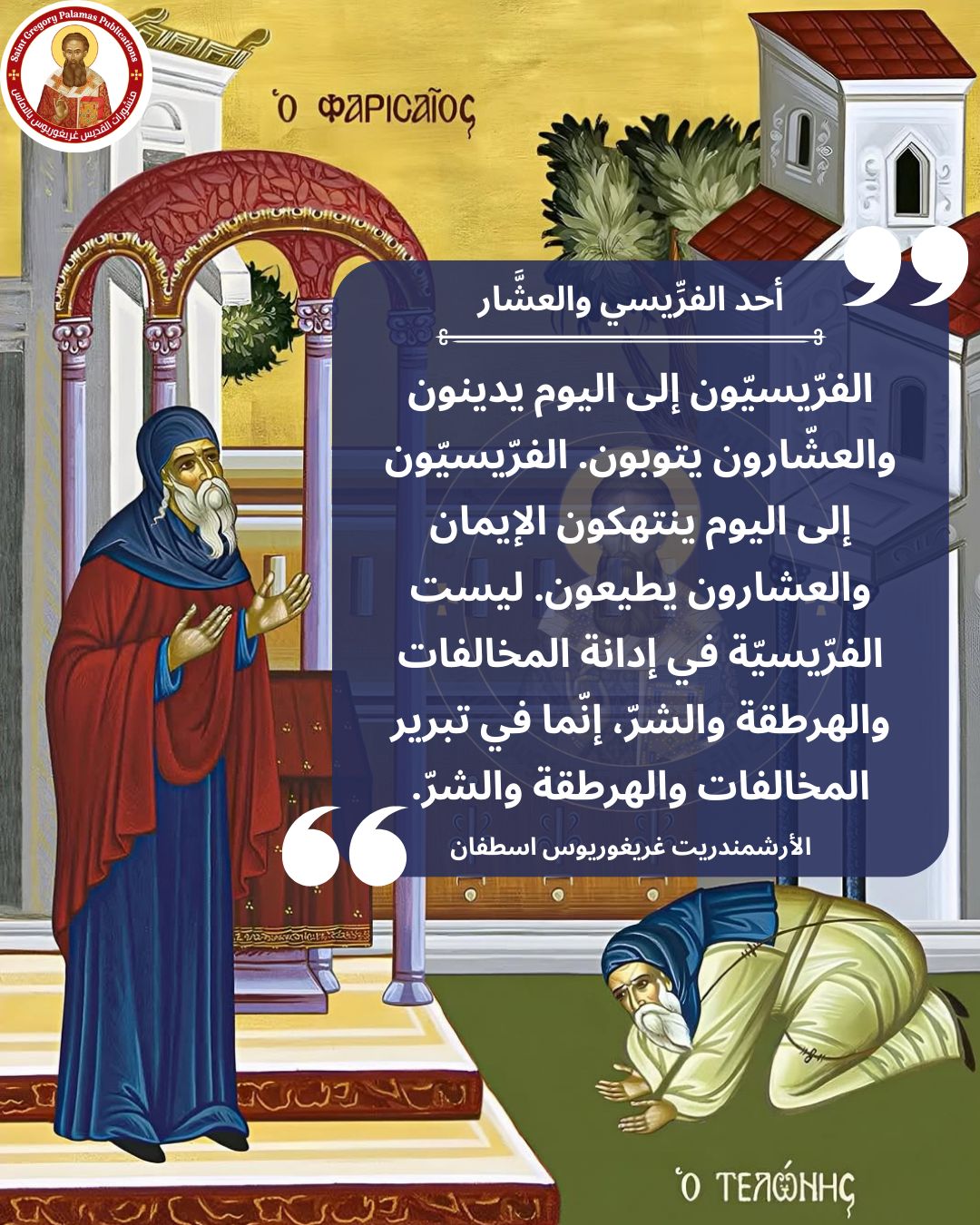الرهبنة المسيحيّة
ما هي الرهبنة؟
الأرشمندريت غريغوريوس اسطفان
رئيس دير رقاد والدة الإله-بكفتين، الكورة
لم تولد الرهبنة المسيحيّة من العدم، إنّما أتت نتيجة حاجة داخليّة في الإنسان. هذه الحاجة هي عطش موجود في الطبيعة البشريّة إلى الكمال والمطلق، يطلب تحقيق شيء غير ماديّ وغير منظور، يُشكّل الغاية التي لأجلها خُلق الإنسان في البدء على هذه الأرض. صعوبة تحقيق هذا الهدف في المجتمع قاد البعض إلى الانسحاب إلى البراري ليتفرّغوا في كلّ حياتهم لتحقيق هذه الغاية. أحد مغبوطي الكنيسة، أوغسطينوس من القرن الخامس، يُخاطب الله هكذا: "لقد خلقتنا متّجهين إليك ولن ترتاح نفوسنا إلا بالسكنى فيك". من البدء قال الكتاب المقدّس أن الله خلق الإنسان "على صورته ومثاله". صورة الله موجودة في طبيعتنا ذاتها، وهذا ما يُبرّر عطش نفوسنا إلى الإله الحيّ. أمّا أن نصير على حسب مثال الله فهذه هي دعوة الإنسان من البدء وغاية كل وجوده.
لكن الإنسان الأوّل، المخلوق على صورة الله، لم يستطع أن يثبت في محبّة الله وطاعته فسقط، وأصبحت حياته تسودها خطيئة الأنانيّة ومحبّة الذات، التي هي جذور كلّ الخطايا؛ فكان لا بدّ من عمل إلهيّ لإنقاذ الإنسان الساقط. لم يأتِ السيّد المسيح إلى هذا العالم لتنظيم حياة البشر على الأرض، ولا ليحسِّن أخلاق البشر، إنّما أتى ليرفع الإنسان من حالة السقوط التي يوجد فيها، ويجعله إنسانًا جديدًا، نقيًّا، كاملاً في الفضيلة والمحبّة، على حسب مثال الله؛ يسلك بالروح لا بحسب شهوات الجسد، مستحقًّا لملكوت الله السماويّ، الّذي هو ملكوت غير ماديّ، روحيّ نورانيّ.
وُجدت الرهبنة في البدء لتحقيق هذا الهدف. الرهبنة المسيحيّة هي في جوهرها رهبنة هدوئيّة، ينسحب فيها الإنسان من مجتمع العالم إلى البراري والأماكن الهادئة ليعبد الله بكليّته، بالنفس والجسد. الهدوئيّة (Hesychasm)، وتعني الكلمة، ذات الأصل اليونانيّ، الصمت والسكينة، هي حركة روحيّة، طريقةُ حياةٍ توحديّة، بداياتها تعود إلى القرن الثالث والرابع. وقد كان هناك دافع عمليّ لهذا الانسحاب من مجتمع العالم المدنيّ، وهو أنّ اهتداء الأباطرة الرومان إلى الإيمان المسيحيّ في بدايات القرن الرابع، بعد اضطهادات دمويّة للمسيحيّين استمرّت ثلاثة قرون، ودخول أعداد كبيرة من الوثنيّين إلى المسيحيّة دفعة واحدة، أدّى إلى فتور الحياة الروحيّة التي كان يعيشها المؤمنون في حياة الكنيسة في العالم. هذا الأمر دفع عددًا كبيرًا من المؤمنين، الّذين أرادوا عيش الكمال المسيحيّ وبلوغ مثال الله في الفضيلة والكمال الروحيّ، إلى الانسحاب إلى البراري، مكرّسين أنفسهم لله بالكليّة. لم تكن نظرة أولئك الرهبان سلبيّة تُجاه حياة المجتمع، إنّما رأوا أنّها تُعيق انطلاقة محبّتهم الكاملة لله. كما أنّها لم تنشأ بسبب تأثّرها بأنماط رهبانيّة أخرى لدى أديان أخرى، لأنّ السيّد المسيح سبق فدعا إلى هذه الطريق حين قال لأحدهم: "إن أرَدت أن تكون كامِلاً فاذهب وَبعْ أملاكَك وأعْطِ الفقراء، فيكون لك كنزٌ في السّماء، وتعال اتبعني" (متّى 21:19). وقال في مكان آخر من الإنجيل: "لأنّه يوجد خِصيانٌ وُلدوا هكذا من بُطون أمّهاتِهم، ويوجد خِصيانٌ خصاهُم النّاس، ويوجدُ خصيانٌ خَصَوْا أنفُسهم لأجل ملكوت السماوات" (متّى12:19). أولئك الّذين خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، بالطبع قول المسيح هو مجازي، أي التخلّي عن الزواج وتكريس حياتهم لله، هم الرهبان.
أمّا بالنسبة لفلسفة الرهبنة فلا يكفي أن نشرح مبادئها العامّة، إنّما ينبغي أن نشرح وإن باختصار، مسيرتها الداخليّة نحو الهدف التي يسعى الرهبان لتحقيقه.
إنّ غاية الحياة الرهبانيّة لدى المسيحيّين هي أن نتمثّل بالله ونتّحد به قدر ما يُستطاع من كائن بشريّ. ولكنّنا لن نبلغ ذلك، كما يعلّم الكتاب المقدّس، إلاّ بالإيمان والممارسة المقدّسة للوصايا الإلهيّة، التي قمّتها المحبّة. هذه المحبّة تُشكّل في المسيحيّة وصيّة إلهيّة، يُسمّيها الإنجيل "عظمى": "تُحِبُّ الرّبّ إلهَكَ من كُلّ قلبِك، ومن كلّ نفسِك، ومن كلّ فكرِك. هذه هي الوصيّة الأولى والعُظمى" (مت37:22-38). هكذا، الرهبنة المسيحيّة هي تكريس كل القلب والذهن والفكر لله، بدلاً من تبعثرهم في أمور هذه الحياة الباطلة. هذه المحبّة ليست بشريّة، إنّما إلهيّة، إنّها ثمرة استجابة الإنسان لانسكاب محبّة الله فيه. لكنّ محبّة الله لا تنسكب إلا في القلوب الكاملة النقاوة، التي أحبّت الله فوق كل شيء آخر. لهذا، غلبة كل الأهواء الفاسدة، وهو ما نسمّيه حالة اللاهوى أو النقاوة الداخليّة الكاملة، تسبق المحبّة.
في التقليد الرهبانيّ النسكيّ، تأتي المحبّة من اللاهوى، وتحقيق اللاهوى يحتاج إلى طريقة الحياة الرهبانيّة الهدوئيّة. الهدوئيّة، في التقليد المسيحيّ الأرثوذكسيّ، لا تعني فقط حياة توحديّة مجرّدة، إنّما هي بالأحرى طريقةُ حياةٍ هدفها تطهير القلب الداخليّ؛ حيث الهدوء الخارجيّ، مترافقًا مع ممارسة الصلاة الداخليّة أو الذهنيّة، يحرّر الحواسَّ والجسدَ من المناظر والصور الخارجيّة التي تقدّمها للنفس وتثيرها، فيُصار حينها مستطاعًا رَصد الأفكار والسيطرة عليها، عبر صلاة ذهنيّة مركّزة.
فأفكارنا قبل السقوط كانت في حالة براءة تامّة، لا تشته سوى ما هو لله، لا تحسد ولا تتفاخر ولا تظنّ السوء ولا تفرح بالإثم ولا تدين أحدًا، بل تتأنّى وترفق وتغفر وتُحبّ من دون غاية ذاتيّة. لهذا كان ذهن الإنسان الأوّل قبل السقوط في حالة نقاوة داخليّة تامّة وتأمّل دائم للخيرات الأبديّة وحوار لا ينقطع مع الإله الخالق. بعد السقوط فقَدَ الإنسان الدالّة التي كانت له لدى الله، فتبعثر ذهنه بسبب الخطيئة ودخلت فيه الأهواء، وأصبح يتشتّت بسهولة في كلّ الأمور الدنيويّة وينسى الله. فقد تحوّل ذهنه من اشتهاء ملكوت الله إلى اشتهاء الأمور الحسيّة، الماديّة والأرضيّة.
تطهير القلب الداخليّ يبدأ بتطهير الذهن والأفكار المتولّدة فيه. إنّ مقاومةِ كلِّ الأفكار من اليمين ومن اليسار، يُعطي الراهب أن يُسيطر على قوى النفس والجسد، وذلك من خلال السيطرة الكاملة على الأهواء والأفكار، بدلاً أن تتحكم به وتسبيه هذه الأهواء والأفكار. إن النفس المملوءة بالصور المختلفة الآتية من الخارج، لا تستطيع أن تصلّي بنقاوة. فالذهن يستلم الأفكار من خلال الأحاسيس كالنظر والسمع أو عبر الذاكرة. لهذا الهدوء والابتعاد عن العالم يسهّل ضبط الذهن بعيدًا عن كل تشتّت. أمّا الهدوء الداخليّ فهو تحرّر الذهن من كلِّ الأفكار والصور والتخيّلات واقتنائه الصلاة التي لا تتوقّف إلى الله. فإن لم تتحرّر النفس من كلّ رباط، لا يستطيع الذهن أن يبلغ الصلاة النقيّة ويتّحد بالقلب. وهكذا، هدوء الجسد يقود إلى هدوء الذهن وسلام الأفكار.
ونعني بالأهواء كل الشهوات الفاسدة التي تُلصق الإنسان بأمور هذه الحياة الدنيوية، وتستعبده وتجعله جسدانيًّا أرضيًّا، مريضًا بالأهواء التي تفصله عن الله وعن إخوته البشر. يُعدّد أحد قدّيسيّ الكنيسة، اسحق السرياني، الأهواء كالتالي: "حبّ الغنى وجمع أشياء شتى، تنعّم الجسد الّذي منه تنشأ الدعارة، الرغبة في الإكرام الّتي منها يأتي الحسد، حبّ الرئاسة، الإنتفاخ بعظمة السلطة، الزينة والإفتخار، المجد البشري الّذي يسبّب الحقد، الخوف على الجسد"[1]. لقد علّم السيّد المسيح في الإنجيل أنّه لا يكفي أن لا نعمل الخطيئة فعليًّا، بل ينبغي أن تموت جذور الخطيئة في داخلنا، أي الأهواء الفاسدة والشرّيرة. هذا يُسمّى تطهير الإنسان الداخليّ أو تطهير القلب الداخليّ، ليولد الإنسان الجديد الّذي على حسب صورة يسوع المسيح.
موت إنسان الغرائز والشهوات والتحرّر من الأهواء، لا يمكن أن يتحقّق من دون طريقة حياة نسكيّة مركّزة. النسك الجسديّ يعني القسوة على الجسد لأجل ضبط توثّباته وأهوائه. لا يمكن للأهواء أن تذبل وتموت من دون ألم وقسوة. النسك الجسديّ يتمّ من خلال الأصوام الطويلة والصلوات المركّزة والسهر الروحيّ وغيرها من الأتعاب. لهذا، الحياة الرهبانيّة النسكيّة تبدأ بالابتعاد عن التنعّم وراحة الجسد، لأنّهما يقتلان كل رغبة في اقتناء الفضيلة. إنّ عدم الحسّ والصلابة وقساوة القلب تولَدُ طبيعيًّا من الرّاحة والتنعّم وسهولة الحياة. ومن الإمساك وتعب الجسد والصلاة المركَّزة يولد انسحاق القلب ووخز الضمير، الّذي يحرّر المرء من كلّ رذيلة. لهذا يحتمل الراهب بوعي كلّ الآلام الّتي يدخل فيها باختياره أو بغير اختياره. فاحتمال هذه الصعاب الطوعيّة يُعلّم النفس أن تقاوم اللّذة الحسيّة والمجد الباطل وتقودها إلى التوبة وإلى احتمال إخوتنا البشر بصبر.
التخلّي عن العالم هو حاجة للراهب الهدوئيّ كي يبلغ محبّة الله. محبّة الإنسان للعالم سببها الرئيسيّ محبّة الإنسان لجسده؛ التخلّي عن محبّة الجسد يقود النفس البشريّة تلقائيًّا إلى محبّة الله.
سلاح الراهب الأوّل في هذه المسيرة النسكيّة هي الصلاة الداخليّة أو الذهنيّة. يُمارس الراهب الأرثوذكسي صلاة مركّزة قصيرة تسمّى "صلاة يسوع": "يا ربيّ يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني أنا الخاطئ". ممارسة هذه الصلاة القصيرة بتواتر تُعطي الذهن أن يتبنّاها مع الوقت، فيردّدها تلقائيًّا بدون جهد. "صلاة يسوع"، التي ينبغي أن يردّدها الراهب في كل وقت ومكان، تهدّئ هيجان الأفكار في الذهن وتطرد الأهواء الفاسدة وتجعل مكانها ذكر دائم لله في النفس، عملاً بقول المزمور: "جعلت الربّ أمامي في كل حين" (مزمور8:16). هكذا تُقاد النفس، عبر هذه الصلاة الحقيقيّة غير المبعثَرة، إلى محبّة نقيّة لله، لا تُزعزعها كل حيل الشياطين.
في الرهبنة المسيحيّة (الأرثوذكسيّة) توجد ثلاثة نذور مُلزمة لكل راهب: 1- العفّة أو البتوليّة؛ 2- الطاعة؛ 3- الفقر أو اللاقنية. هذه الفضائل الرهبانيّة مرتبطة بمواجهة الأهواء الثلاثة الرئيسيّة، التي تُعتبر سبب وعلّة كلِّ الأهواء الأخرى: شهوةُ الجسد، وشهوةُ الغنى، والمجد الباطل أو العُجب. منذ البدء، هذه الأهواء الثلاثة تسيطر على العالم بقوّة، وكل شرور العالم والحروب والصراعات المختلفة تحصل بسببها، أو بسبب واحدة منها على الأقل. الراهب هو الّذي قَبِل الفقر بإرادته وترك التمتع بالخيرات الأرضية، وبهذا التجرّد يُواجه هوى شهوة المال؛ عدم القنية يُساعد الراهب على عدم التعلّق بأي شيء على هذه الأرض. ومن خلال الطاعة وتسليم مشيئته لأبٍ روحيّ يتنكّر للكراماتِ الدنيويّة ويطلب فقط مشيئة الله في حياته. وبالعفّة يُواجه أهواء ملذّات الجسد؛ لأنّ البتوليّة تُعمّق قدرة محبّته لله. من استطاع غلبة هذه الأهواء الثلاثة يكون قد غلب الشرّ والفساد في داخله، ويستطيع بسهولة أن يغلب كل الشهوات والأهواء الشرّيرة الأخرى، وأن ينمو في محبّة الله.
في المسيحيّة، لا يوجد صلاح بشري، كل صلاح حقيقي يستمدّه الإنسان من لدن الله، عبر تطبيق وصاياه الإنجيليّة بدقّة. نهاية حفظ الوصايا والتمثّل بالمسيح واقتناء الفضائل، على قدر استطاعة الإنسان، توجد في حالة اللاهوى، الّتي يبلغها الإنسان المجاهد بالروح. حالةُ اللاهوى هذه، في الخبرة الأرثوذكسيّة، تختلف جذريًّا عن مفهومها لدى الفلسفات الرواقيّة والأفلاطونيّة الجديدة وغيرها. ففي التقليد الآبائيّ، اللاهوى ليس موتًا للجزء الأهوائيّ إنّما تحوُّله ونقله من الشرّ إلى الخير، وفي توجيه مسيرته من الحسيّات إلى الإلهيّات. العادم الهوى هو الّذي استأصل كلَّ شرٍّ وإثمٍ وخطيئةٍ فيه واقتنى الفضيلةَ، وقد أخضع شهوةَ الغضب وشهوةَ اللّذة، اللتين تؤلّفان جزءَ النفسِ الأهوائيّ، لملكات العقل والمعرفة.
القدّيس مكسيموس المعترف، من القرن السابع، يميّز أربع درجات في بلوغ اللاهوى، كلُّ واحدة تقود إلى الأخرى. الدرجة الأولى تفترض الابتعاد الكليّ عن الخطيئة الفعليّة؛ هذه تميّز المبتدئين. الدرجة الثانية، هي رفضُ الأفكار المحمّلة بالأهواء من الذهن؛ هذه تخصّ المجاهدين لأجل الفضيلة. الدرجة الثالثة، تفترض انعدام الحركة والرغبة تجاه الأهواء؛ هذه تُميّز المُتقدّمين نحو الثيوريّا أو المعاينة الإلهيّة. الدرجة الرابعة، بلوغ اللاهوى حيث يكون التطهّر الكامل من الأهواء، وحتّى من أبسط تخيّل يظهر في الذهن[2].
هذه الحالة من اللاهوى المطلوبة من الإنسان هي بشريّةٌ لا ملائكيّة؛ فالمستوى الّذي تبلغ إليه النفس هو بحسب قدرة الطبيعة البشريّة. هنا يصير استئصال جذور الخطيئة من النفس، ويصل الهدوئيّ لا فقط إلى عدم ارتكاب الخطيئة، إنّما أيضًا إلى بُغض الشرّ وكل هوى خاطئ. إنّ الإنسان يعرف، دونما خطأ، أنّه في اللاهوى، من خلال شعوره بفيضٍ من النور لا يُنطق به وبحبٍّ لله وللصلاة لا يُعبّر عنه.
بعد اللاهوى تسكن الفضيلة في النفس البشريّة، وقمّتها محبّة الله التي لا توصف. يقول السيّد المسيح: «من يُحبّني يحفظ كلامي ويُحبّه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلاً» (يو23:14). لأنَّ المحبّة هي كمالُ الفضائل، فهي تتشبّه بالله في كل فضيلة، كما يقول الإنجيل: "الله محبّة، مَن يثبت في المحبّة يثبت في الله والله فيه" (1يو16:4). هذه المحبّة هي قوى الله غير المخلوقة، التي يصير من خلالها الإنسان على شبه الملائكة، أو في حالة ملائكيّة من نقاوة لا توصف للذهن والنفس والقلب. هكذا تبلغ النفس إلى تحقيق المثال الإلهيّ ودعوة الله إلى التشبّه به في الكمال: "فكونوا أنتُم كاملين كما أنّ أباكُم الّذي في السّماوات هو كامِلٌ" (متّى48:5). هنا تتحقّق معاينة الله ومجده في النور الإلهيّ غير المخلوق. وذلك عملاً بقول السيّد المسيح في الإنجيل: "طوبى لأنقياء القلوب لأنّهم يُعاينون الله" (متّى8:5). هذه المعاينة ليست فقط في الدهر الآتي، إنّما تبدأ في هذا الدهر الحاضر. وتُعتبر ممارسة هذه الطريقة الهدوئيّة، حجر الزاوية الّذي لا بدّ منه، في مسيرة الجهاد الروحيّ لأجل الكمال والاتّحاد بالله.
وفي كلّ هذه المسيرة، على الراهب أن ينمو في التوبة والتواضع، عالمًا أن كلّ فضيلة يحقّقها هي عطيّة من الله، وإلا خسرها وسقط في الضلال. فالإنسان المخلوق والمحدود لا يملك في الحقيقة أيّة قدرة تخوله أن يرى الله غير المخلوق وغير المحدود؛ وإذا كانت هناك من رؤيا لأنقياء القلوب من كل هوى، فذلك أنّ الله نفسه يتّحد بالإنسان ويكشف ذاته له، جاعلاً إياه مشاركًا في خبرة معرفته ومعاينته، في هذه الحياة الحاضرة ذاتها.
هذا لا يعني أنّ الخلاص هو حصرًا للرهبان إنّما الّذين ابتعدوا عن العالم يطرحون بسهولة الأهواء الرديئة. أمّا العائشون في العالم، فبسبب كثرة معرفة الشرّ المحيط بهم، عليهم أن يُجاهدوا كثيرًا في طرد هذا الشرّ من أذهانهم؛ وأن يغصبوا ذواتهم كي يستعملوا أشياء العالم بتجرّد وبنسك وفق وصايا الله. الحياة الرهبانيّة النسكيّة توفِّر الظروف المؤاتية لهذا النموّ الروحيّ والخلاص.
هذه الخبرة الروحيّة، خبرة معاينة نور الله غير الماديّ وغير المخلوق، هي خبرة إسخاتولوجيّة، وقد اختبرها العديد من القدّيسين في هذا الدهر الحاضر. في العهد القديم، لما سطع مجد هذا النور على وجه موسى المغبوط، وما كان بوسع أحدٍ أن يشخص إليه، لم يكن سوى دلالة على كيفيّة تمجيد أجسام القدّيسين عند قيامة الأبرار. هذه الخبرة ذاتها كشفها السيّد المسيح في تجلّيه على جبل ثابور.
أبرز الرهبنات في لبنان بالطوائف المسيحيّة المختلفة وما الفرق بينها؟
الرهبنات الموجودة في لبنان هي إمّا كاثوليكيّة (الموارنة هم جزء من هذه الكنيسة)، وإمّا أرثوذكسيّة. الرهبنات الكاثوليكيّة تتبع نظام الطغمات، حيث توجد طغمة رهبانيّة لها أديار عدّة ورئاسة عامّة تُدير هذه الأديار، يتغيّر الرؤساء ويتبدّلون في وظائفهم. الرهبنات الأرثوذكسيّة هي أديار مستقلّة الواحد عن الآخر، في كل واحد هناك أب روحيّ يجتمع إليه أبناء روحيّين يصيرون رهبان ويبقون كلّهم في الدير إلى النهاية، خاضعين لأسقف الأبرشيّة، من دون أن يكون للأسقف الحقّ بالتدخل في حياة الدير الداخليّة.
هذه الرهبنات تتبع نموذجين مختلفين لطريقة الحياة الرهبنة. وهذان النموذجان موجودان في لبنان وفي العالم المسيحيّ عامّة: الأول: الهدوئيّة، التي تكلّمنا عنها، وهذه الطريقة تتّبعها الكنيسة الأرثوذكسيّة، وهي طريقة الحياة الرهبانيّة النسكيّة كما كانت تُمارس من البدء. والثانية: الرعائيّة، وتتّبعها عامّة الكنائس الكاثوليكيّة، مع وجود أقليّة في لبنان، تتبع الكنائس الكاثوليكيّة، تُمارس الطريقة الهدوئيّة.
الفرق بين الإثنين يكمن في أنّ الطريقة الهدوئيّة تكمن في الانسحاب الكامل من العالم، وخدمة العالم روحيًّا عبر الصلاة والإرشاد الروحيّ. أمّا الرعائيّة فهي تكمن في خدمة العالم عمليًّا، عبر تأمين الخدم الليتورجيّة للرعايا؛ أو عبر المؤسّسات المختلفة التي ينشئها ويُديرها الرهبان أو الراهبات. فالوقت الّذي يضعه الراهب الهدوئيّ في الصلاة يضعه الرعائيّ في الخدمة الفعليّة الميدانيّة للمجتمع، مع إعطاء أوقات محدّدة للصلاة.
ما هي العلاقة بين الرهبنة وبين الكنيسة؟ كيف مبنيّة؟
من وجهة النظر الأرثوذكسيّة، الرهبنة هي حركة هدوئيّة نسكيّة، شدّدت دائمًا على عيش الجانب الروحيّ البحت للإيمان. لهذا هي إحدى مواهب الكنيسة الأساسيّة، وهي خاضعة للكنيسة في كل شيء. مثّلت الرهبنة دائمًا التيار الروحيّ التقليديّ وواجهت التحدّيات التي كانت تخضّ الكنيسة عبر التاريخ على صعيدين: إيمانيّ وروحيّ.
على صعيد الإيمان، في مواجهة الحركات العقلانيّة المختلفة لمقاربة الإيمان والعقيدة. الحركات العقلانيّة استندت على الفلسفة، وقد حاولت في أوقات عديدة في التاريخ أن تُعقلن الإيمان الحيّ وذلك عبر تحويله إلى قناعات عقليّة منطقيّة تقتل خبرة معرفة الله الحيّة.
على مرّ التاريخ الكنسيّ، لعب الرهبان دورًا أساسيًّا في المجادلات العقائديّة والدفاع عن الإيمان والحقائق المعلنة المسلَّمة للكنيسة، دون الحلول محل السلطة الهيرارخيّة التي تُعتبر حافظة ومسؤولة أولى عن كل ما يتعلّق بالإيمان والأسرار الليتورجيّة.
على الصعيد الروحيّ، استطاعت الكنيسة الأرثوذكسيّة، على مدى التاريخ، بفضل الرهبنة الهدوئيّة، أنْ تحفظ نفسها من أن تمتصَّها روحُ هذا العالم، وأن تخدم المجتمع وتوجّهه نحو المسيح دون أن تتأثّر بدهرنة فكر المجتمع. الكنيسة الموجودة في العالم تتأثّر بسهولة بروح العالم والعلمنة، أي الروح الدنيوية. والمؤمنون، الذين يعيشون ويجاهدون في العالم، ويتعرّضون إلى ضغوطات وتجارب كثيرة، بحاجة إلى آباء روحيّين، يعترفون لهم وينالون الإرشاد الروحيّ اللازم ليعبروا هذه الحياة المملوءة بالصعوبات وتجارب الشياطين والمغريات الأرضيّة، التي تشدّ الإنسان إلى اشتهاء أمور هذا العالم الزائل ونسيان ملكوت المسيح. ومن الأديار كان المؤمنون يتعلّمون دائمًا هذه الأمور الخلاصيّة. بهذه الطريقة تُعطي الرهبنة قوّة روحيّة عظيمة للكنيسة، تحفظها من روح العالم الفاسدة وتُثبّت مسيرتها نحو المسيح وملكوته السماويّ.
في تعليمنا المسيحيّ، إنّ دينونة هذا العالم الأخيرة ستحصل حين يستفحل الشرّ والفساد فيه، ولا يبقى هناك قدّيسون يُصلّون لأجل خلاصه. لهذا، الصلاة هي تقدمة الراهب الأولى لا فقط للكنيسة وإنّما للعالم كلّه. صلوات أولئك الّذين يقدّسون ذواتهم وهم أحياء بعد، قادرة أن تؤثّر حتّى على نظام الطبيعة. العالم يحتاج أولاً إلى الصلاة، وهذه الخليقة مستمرّة، رغم الشرور والفساد الّذي يتآكلها، بفضل توبة الرهبان وصلواتهم غير المنقطعة للعالم أجمع. هذه الصلاة هي الرسالة الأعمق والخدمة الأسمى التي يمكن للراهب أن يقدّمها للعالم، وفي هذا تكمن كل قوّة الرهبنة. الصلاة الكاملة هي طعام النفس الحقيقيّة، إنّها محادثة مع الله وجهًا لوجه، تستدرّ رحمة الله لهذه الخليقة من دون توقّف. والعالم يحتاج إلى أماكن للصلاة، وإلى أناس اختبروا حياة الصلاة والنقاوة ودخلوا بعمق في الحياة التي بحسب الروح. يحتاج إلى أناس زهدوا كليًّا بهذا العالم الزائل، وأصبحوا قادرين من خلال صلاة حقيقية داخلية قلبيّة أن يُكلّموا الله وأن يسمعهم الله ويُحقّق طلباتهم، يقول السيّد المسيح: "كل ما تطلبونه في الصلاة بإيمان تنالونه" (متّى22:21). فالراهب، رغم أنّه منفصل عن حياة المجتمع لكنّه متّحد بالكل بالمحبّة النقيّة المعبّر عنها بصلاة لا تتوقّف لأجل خلاص كلّ العالم.
[1] القدّيس اسحق السريانيّ، نسكيّات، تعريب الأب إسحق عطالله الآثوسيّ، دير رئيس الملائكة ميخائيل، نهر بسكنتا 1998، 30، ص 130-131.
[2] Μαξίμου Ομολογητού, Πρός Θαλάσσιον, 55, PG. 90, 544C; Κεφάλαια Διάφορα, Γ΄, 51, PG. 90, 1281C; Πρός Θαλάσσιον, 55, σχόλ. 21-24, PG. 90, 565BC; Πρβλ. Ανέστη Γ. Κεσελόπουλου, σ. 181-182.
آخر المواضيع
كلمة قدس الأرشمندريت غريغوريوس اسطفان في صلاة الغفران
الفئة : عظات اﻷرشمندريت غريغوريوس اسطفان
إدانة الخطأ وإدانة الخطأة
الفئة : عظات اﻷرشمندريت غريغوريوس اسطفان
غاية الحياة المسيحيّة ومعرفة الله
الفئة : عظات اﻷرشمندريت غريغوريوس اسطفان
النشرات الإخبارية
اشترك الآن للحصول على كل المواد الجديدة الى بريدك الالكتروني