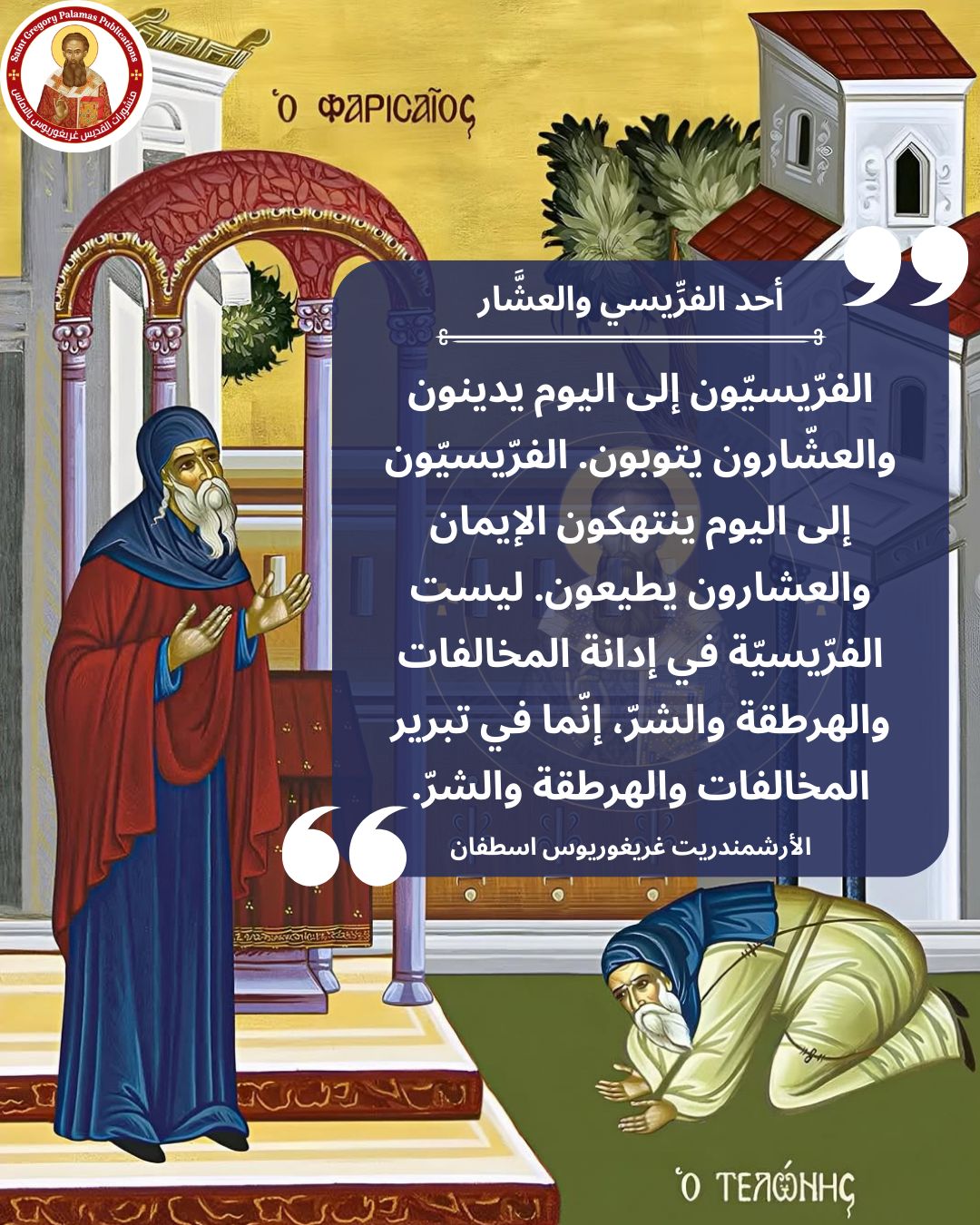كيف أرى الله وأنا حي

محاضرة للأرشمندريت المتوحّد غريغوريوس اسطفان
ألقاها في كنيسة القدّيس ديميتريوس الأشرفيّة 2018
هذا الموضوع هو هدف حياتنا بالرغم من دقّته وصعوبته، وهو الهدف الذي من أجله خلق الله الإنسان، كما هو مذكورٌ في بداية سفر التكوين. أعطانا الله نعمة المجيء إلى هذه الحياة مرّة واحدة، لكنّه لم يخلقنا لكي نأكل ونشرب ونتزوج ونموت، إنما خلقنا من أجل هدف أسمى من ذلك بكثير، خلقنا لكي نتحد به. يطلق الآباء القديسون تسمية "الحياة مع الله" أو "الشركة مع الله" على هذا النمط من العيش. لهذا منحنا الله كلّ شيء، كلّ الخليقة، وإعتنى فينا منذ بداية الخلق حتى الآن.
نحن الآن في زمن الصوم الكبير، ومن يتابع هذه المسيرة عن كثب يلاحظ التدرّج الذي وضعته الكنيسة في هذه الفترة بدءًا من آحاد التريودي وصولاً إلى القيامة. إذا تابعنا هذه المسيرة بطريقة صحيحة نكون سائرين في الطريق الذي يقودنا إلى معاينة الله والإشتراك معه في قيامته. تُتَوَّج هذه المسيرة بالعنصرة وحلول الروح القدس الذي يجعل القيامة فاعلة وحيّة في داخلنا.
تتطلّب معاينة الله أولاً إيمانًا مستقيمًا، إذ بدونه لا يمكن أن توجَد حياة مستقيمة، ولا يمكن أن يكون هناك نمو في معرفة الله. لذلك وَضَعَت الكنيسة أحد الأرثوذكسية وأحد القديس غريغوريوس بالاماس في بداية الصوم، مشيرةً إلى أن الإيمان والعقيدة هما الأساس الذي تُبنى عليه حياتنا في المسيح. نحن نحيا في زمنٍ يتمحور حول الحياة الخارجيّة والمحبّة السطحيّة، دون التركيز على الداخل أي على الإيمان. يقول القديس إسحق السرياني: "إيماننا بالله هو من جهة محدود أي تحدّه العقيدة (نحن لا نستطيع أن نتجاوز تحديدات الكنيسة العقائديّة)، ومن جهة أخرى هو غير محدود لأن الإيمان يشدّد الخبرة الخفيّة للحقائق الإلهية التي نعيشها (أي خبرة عيشنا مع الله غير محدودة)". ويقول أيضًا: "هذا الإيمان يعلن الأسرار الخفيّة في النفس والغنى الإلهي المحجوب عن أبناء الجسد والمُعلَن بالروح لأولئك الذين يأكلون الطعام على مائدة المسيح والذين يهذون بناموسه".
الأحد الثالث من الصوم هو أحد السجود للصليب، فهو رمز لموتنا وقيامتنا مع المسيح. الصليب ليس مجرَّد حدث تاريخي مضى، ولا يُعلِن أن الرَّب تجسَّد ومات من أجلنا، بل تجسَّد الرَّب لنتمكَّن من مشاركته في موته بموتنا عن خطايانا، فنقوم معه وننتصر على كلّ ما كان يستعبد الإنسان قبل قيامة المسيح. لذلك نركِّز على أن بداية حياتنا مع الله ومسيرتنا نحوه تكون بالمعموديّة، ننطلق منها ونغتذي بالطعام الإلهي أي جسد المسيح ودمه. لذلك كانت الكنيسة حازمة في مواجهة الهرطقات عبر التاريخ. فكلّ هرطقة وكلّ إنحراف عن الكنيسة يمنع الإنسان من الوصول إلى الهدف أي إلى الإشتراك الحي مع الله.
أراد الله أن ينمو الإنسان ليتمكن من معاينته، لكن الإنسان اختبأ. إختبأ آدم ولم يعد قادرًا على رؤية الله. الله لم يختبئ عن آدم، لكن آدم إختبأ لأنه أخطأ وعصى وصيّة الله. ونحن بسلوكنا حياة الخطيئة والعصيان نختبئ ولا نستطيع أن نعاين الله. فالخطيئة تحجب الله عنّا، لذلك علينا أن نجاهد بغية التخلُّصِ من الخطيئة. عندما خلقنا الله على صورته ومثاله، خلق فينا إمكانية معاينته، لكننا شوهنا صورته فينا، وعبر الجهاد نستردّ الجمال الأول لصورة الله لنصبح مشاركين له في الحياة الإلهية.
يتكلَّم القديس غريغوريوس بالاماس عن مثلَّث يقود إلى معاينة الله. فمسيرة الإنسان لمعاينة الله هي مسيرة ثلاثية تبدء بحفظ الوصايا (وصايا الإنجيل)، ونقاوة القلب (من يحفظ الوصايا يصل إلى نقاوة القلب)، والثاوريا أي رؤية الله. "بعد حفظ الوصايا توجد نقاوة القلب التي هي غاية الجهاد الروحي ...وكلّ وصيّة إلهية وكلّ شرعة مقَدَّسة تنتهي بحسب الآباء بنقاوة القلب". بهذا القول نتذكر قول الرَّب "طوبى لأنقياء القلوب لأنهم يعاينون الله" (متى5: 8). يُكمل قديسنا قائلاً: "وبعد نقاوة القلب توجد أشياء أخرى كثيرة، عربون خيرات الدهر الآتي الموعود بها منذ الدهر". أي يمكننا أن نعيش خيرات الدهر الآتي في هذا العالم.
يقول القديس غريغوريوس السينائي (القرن 14م): "أطلب الرب في قلبك عبر تطبيق الوصايا، لأننا حين نسمع صوت يوحنا المعمدان يصرخ في البريّة، أعدّوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة، يجب أن نعلم أنه يُشير إلى الوصايا وإلى تطبيقها في القلب والفهم. إنه مستحيل أن تكون طريق الوصايا مستقيمة وأن تعمل بها ما لم يكن قلبك أيضًا مستقيما". وصايا الإنجيل مختلفة كليًا عن الوصايا الأخلاقية التي نعيشها في المجتمع. فإذا طبقنا وصايا الإنجيل نصل إلى نقاوة القلب. أما الوصايا الإجتماعية تهتم بما هو خارجي، فتصبح أولوياتنا ألا نخطئ أمام الناس، ولا نكترث لكمّ الخطايا الداخليّة التي نقترفها. من يعيش بهذه الطريقة هو إنسانٌ بعيد عن المسيح. فالمسيح نعيشه في داخلنا عندما نبدء بتطبيق وصايا الإنجيل.
كيف نطبِّق وصايا الإنجيل؟
تطبيق الوصايا ليس بأمرٍ سهلٍ، لذلك نرى أن العالم يعيش ضدّ وصايا المسيح، إذ يهمّه شكل الوصيّة لا جوهرها. يُعلِّمنا الآباء القديسون أن طريق حفظ الوصايا يبدء بالزهد. من يريد تطبيق الوصايا عليه أن يكون حرًّا من كلّ الملذات العالميّة. فالزهد هو استخدام الخيرات العالمية بطريقة نسكيّة إنجيليّة، كما يقول القديس بولس الرسول: "الوقت منذ الآن مقَصَّرٌ، لكي يكون الذين لهم نساءٌ كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كـأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه" (1كور7: 29-31). ليس المطلوب أن يكون الجميع رهبانًا، لكن علينا استخدام خيرات العالم وكأننا لا نستخدمها، وأن نملكها وكأنّنا لا نملكها، هكذا يبقى تعلّقنا بالمسيح وليس بما نملك. على المتزوجين أيضًا أن يكونوا وكأنهم غير متزوجين، أي لا ينحصر تعلّقهم ببعضهم البعض، بل بالمسيح. هذه هي بداية الطريق في تطبيق وصايا الإنجيل. نعبِّر عن محبّتنا للمسيح بحفظ وصاياه؛ "إن كنتم تحبّونني فاحفظوا وصاياي" (يو 14: 15). عندما أعطانا الرَّب الوصايا أعطانا معها نعمة التمييز بين الخير والشَّر، فصار الإنسان مسؤولاً عن كلّ أعماله.
الزهد من أجل تطبيق الوصايا صعب، وعلى الإنسان أن يغصب نفسه. يقول القديس غريغوريوس بالاماس في هذا الشأن: "حفظ الوصايا يحتاج إلى غصب الطبيعة التي تميل إلى الأهواء ومحبّة أمور العالم". هذا الغصب، بحسب القديس غريغوريوس بالاماس، يكون صعبًا في البداية، لكن إذا إستمرَّ الإنسان في هذا الجهاد بغية التحرّر من الملذات العالمية، يُصبح هذا الغصب سهلاً وطبيعيًا. حينها تكتسب النفس كرهًا للشهوات والأهواء، ونندفع نحو اللاهوى الذي بدوره يدفعنا نحو الصلاح الوحيد الذي هو يسوع المسيح.
يصل الإنسان بعد حفظ الوصايا إلى نقاوة القلب. ميّز آباء الكنيسة بين القلب والعقل، فالقلب ليس فقط المركز الأساسي في الجسد إنما في الروح أيضًا، كلّ الأحاسيس والمشاعر موجودة في هذا القلب. لذلك عندما يتكلّم الإنجيل عن القلب ونقاوة القلب، يتكلّم عن القلب الروحي الذي يزرعه الله في القلب الجسدي. أما العقل فهو قادرٌ على معرفة الأشياء المخلوقة التي تُحيط بنا، لذلك هو ينفعنا ويضرّنا في الوقت عينه. فإذا إتّكل الإنسان على عقله فقط ليعرف الله، سيصل حتمًا إلى طريق مسدود، لأن العقل البشري محدودٌ ولا يمكنه معرفة الله. العقل هو باب القلب، فعندما يقبل أفكارًا شريرة يُدخلها إلى القلب، وإذا رفضها تبقى خارجه. إذًا للعقل دور مهم في الحياة المسيحيّة، فهو الذي يساعد الذهن على التطهر والذهن بدوره يساعد القلب على التطهّر.الذهن بحسب الآباء القديسين هو وسيط بين العقل والقلب، العقل يؤثر على الذهن والذهن يؤثر على القلب. يقول القديس باسيليوس الكبير: "في الإنسان المسيحي الذي أصبح هيكلًا لله بالروح الكلي قدسه، العقل والقلب يوجدان ويعملان معًا، العقل يهتم بالأمور الأرضيّة والقلب يهتمّ بذكر الله الذي لا ينقطع".
يقول القديس غريغوريوس بالاماس: "الذهن الذي يتشتت بالأمور الأرضيّة، يفتح بابًا للأهواء"، ويسمّيه الذهن الضّال. ويُكمل قائلًا: "لأجل شفاء الذهن وعودته إلى ذاته ينبغي قطع السيل الداخلي للأفكار الشريرة بوسائل الصلاة والتواضع. فالصلاة والتواضع يقدّسان الجسد ليصير الكلّ مقدَّسًا، هناك يتطهّر الذهن من كلّ فكرٍ أو تخيّلٍ ثم يرتفع إلى الله حيث يقف أمامه أصمًّا وأخرسًا. هذه هي مسيرة الإنسان من الصورة إلى المثال".
تتبادر الأفكار - في هذا العالم - إلى ذهننا بشكل طبيعي، أمّا الإنسان قبل السقوط لم تشتّته الأفكار والتخيّلات. كل هذه الأفكار تعَبِّر عن حالة السقوط التي نحياها. ولا يمكن أن تتطهَّر هذه الأفكار إلّا بالصلاة والتواضع. كلّ ما اهتممنا بالأشياء الدنيوية الخارجيّة نفتح بابًا للأهواء. من المؤسف أنه لدينا فضولٌ لمعرفة كلّ ما يجري في هذا العالم، لكن عندما نقف للصلاة نجد أنفسنا متعبين، بالرغم من كون الصلاة الطريق التي تساعدنا لتجميع الذهن، وتجميع قوى النفس المشتّتة. يتكلّم الآباء عن العمل إلى جانب الصلاة في الجهاد الروحي، لا يقصدون العمل الطبيعي إنما العمل النسكي (Praxis). تسود علينا طبيعتنا البشريّة في عالمنا وليس العكس، هي التي تسيّرنا، والطريقة الوحيدة لضبط أهوائنا هي التعب الروحي.
يستطيع الإنسان أن يتحمّل الجهادات النسكيّة التي تعلّمها الكنيسة، كالأصوام والأسهار والصلوات، وهي تساعده على تطهير الجزء الشهواني الكامن فيه. يقول أفلاطون إن النفس تتألّف من ثلاثة أجزاء، الجزء العقلاني، والجزء الشهواني، والجزء الغضبي. هنا أيضًا نجد مسيرة معيّنة، إذ على الجزئين الشهواني والغضبي أن يخضعا بدايةً للعقلاني، فتكون مسيرتهم صحيحة. كما أن الجزء الشهواني لا يمكن أن يتطهَّر إلّا بالنّسك. النسك هو الطريق الذي يتبعه كلّ إنسان، حسب إمكاناته، فالمطلوب من الرهبان يختلف عن ما هو مطلوبٌ من العلمانيين، لكن على كلّ إنسان أن يختبر شيئًا من هذه الحياة. الرّهبنات الغربيّة تفهم العمل من الناحية الإجتماعيّة، أمّا بالنسبة لنا فهو الجهاد النسكي الذي يمكّننا من السيطرة على أهوائنا.
كيف يعيش الإنسان هذه الناحية النسكيّة من حياته؟
الصلاة هي أساس يتّبعه الإنسان في جهاده، لكن لا يجب أن تُحصر فقط ضمن إطار الصلوات الثابتة في الكنيسة. الصلاة هي الإلتقاء بالله، الحديث معه، ليست مجرّد واجبات. الإنسان الذي لا يصلّي يُغيِّب الله عن حياته. الصلاة هي تدريبٌ، هي هذيذٌ باسم الرَّب، ومن خلالها يحضر الله فينا. يُفترض أن يُتمّم كلّ إنسانٍ، واجباته الإجتماعيّة والعائليّة على أكمل وجهٍ، لكن عليه أن يترك وقتًا للصلاة. بقدر ما يستغلّ وقت الفراغ للصلاة، بقدر ما تعمل فيه نعمة الله. فالله ليس غريبًا عنا، بالرّغم من أننا لا نراه لكنّه حاضرٌ وهو يتابع كلّ تفاصيل حياتنا، ويرى كلّ تضحية نبذلها من أجله. عندما يرانا في هذه الحالة، ويرى شوقنا إليه، يُعطينا نعمةً خاصّة، نعمة حضوره فينا. ونشعر بذلك حتى في الأوقات التي لا نصلّي فيها. كلّ هذا هو عطيّة من الله، يعطيها لكلّ إنسانٍ يراه مشتاقًا إليه. علينا أن نُبعد كلّ ما يُشتّتنا عن الحياة مع الله، علينا أن نضحّي بسلوكنا هذه المسيرة، مسيرة الصلاة.
لنصل إلى الصلاة الحقيقيّة يجب أن نتحرَّر من كلّ همٍّ دنيوي، وأن نغذّي إيماننا بالرّب، فهو موجودٌ معنا وسيساعدنا لنعبر كلّ التجارب والصعوبات. يقول القدّيس غريغوريوس بالاماس: "علينا أن ننكبّ على الصلاة الدائمة المتيسّرة لنا في أيّ وقتٍ، بأعمالنا وأفكارنا، إلى أن ننال العطيّة"، هذه العطيّة هي النعمة، عطيّة الرّوح القدس. كما يقول: "لا بدّ من التواضع، لأنّ الله لا يُسرّ بصلاة المتكبّرين والذين يدينون الآخرين". نحن نحيا في عالمٍ، يريد الإنسان أن يكون وحيدًا فيه، وأن يكون الآخرون في مرتبةٍ أدنى منه. هذه الأنانية التي يزرعها فينا المجتمع تدفع الإنسان إلى التكبُّر. يقول القدّيس بالاماس في هذا الشّأن: "المتواضعون هم وحدهم بشرٌ حقيقيّون، وحدهم يملكون كرامةً أكثر من الحيوانات غير الناطقة، والذين ليسوا متواضعين ليسوا بشرًا، أو هم أسوأ من الحيوانات غير الناطقة وإن كانوا بالطبيعة يُحسَبون بشرًا". يقول الآباء إنّ الإنسان المتكبّر يماثل الشياطين، فالشيطان كان ملاكًا لكنّه سقط بسبب التكبّر. التكبّر هو أساس كلّ سقطٍ وابتعادٍ عن الله. إذًا، لا بدّ من التواضع في مسيرتنا، فالتواضع يجعل الإنسان قادرًا على ترك كلّ ما هو دنيوي، وأن يعود إلى نفسه ويدين نفسه، وأن ينظر إلى خطاياه بدلًا من النظر إلى خطايا الآخرين.
تاليًا، لا بدّ من تطبيقٍ جديّ للصوم والصلاة والممارسات الأخرى، لأننا لا نستطيع أن نتخلّص من أهوائنا دون ألمٍ. نتألم في حياة النسك، وهذا الألم يضبط الأهواء. كلّ هذه الأصوام على مدار السّنة هي ضروريّة إذا أراد الإنسان أن يكون جديًّا في مسيرة ضبط أهوائه. يقول القدّيس غريغوريوس بالاماس: "النسك لا بدّ منه في مسيرتنا والألم الجسدي وحده يُميت قابليّة الجسد للخطيئة، ويُخفّف الأفكار التي تُثير الأهواء العنيفة". نجد في كتاب التريدوي هذه الجملة "إن موسى بالصيام نقّى حدقتي النفس فعاين الله". هكذا الصلاة والصوم تُغيّر مسيرة الإنسان فبدل أن تكون طبيعتنا مائلة إلى الأمور الأرضيّة، تميل إلى اشتهاء الأمور السماويّة.
يتكلّم القدّيس غريغوريوس بالاماس عن نقاوة القلب قائلًا: "كلّ وصيّة إلهيّة وكلّ شرعةٍ مقدَّسة تنتهي حسب الآباء بنقاوة القلب". نقاوة القلب هذه هي ثمرة الصلاة النقيّة، ثمرة جهادنا وثمرة سُكنى الرّوح القدس فينا. كلّ ما نحقّقه في هذا الجهاد يتمّ بنعمة الرّوح القدس، أي أنّ جهادنا ليس نابعًا من قوتنا الخاصّة بل من طلبنا معونة الله في كلّ مسيرة الجهاد. يرى الله مقدار تعبنا ويُعطينا حسب هذا المقدار. نعمة الرّوح القدس نفسها تؤهّلنا لمعاينة الله، كما نردّد في صلواتنا "وبنورك نعاين النّور"، أي بنور الله نعاين الله. هو يعطينا هذه النعمة، إنّنا مخلوقون ومحدودون، لكننا نستطيع أن نرتفع فوق هذه الطبيعة المخلوقة لنعاين الله. لهذا حاربت الكنيسة الهرطقات، لأنها تمنع الإنسان من السّير في هذا الطريق، والوصول إلى هذه الحالة، حالة سكنى الرّوح القدس فيه.
يقول القديس إسحق السرياني واصفًا الإنسان الذي وصل إلى نقاوة القلب: "كيف يرى الإنسان أن قلبه صار نقيًا؟ حين يرى جميع الناس أنقياء، حين يلتهب بمحبّة الله ومحبّة كلّ إنسانٍ آخر، لا بل ومحبّة كلّ الخليقة بذاتها. يتألّم مع المتألّمين، وكأن ألمهم هو ألمه ويفرح مع الفرحين وكأنه فرحه... يكون الإنسان نقيّ القلب بالفعل عندما يرى أنّ جميع الناس صالحون ولا يبدو له أحد منهم مدنّسًا". ويقول القدّيس غريغوريوس اللّاهوتي: "النّقيّ فقط يعاين النّقيّ"، الله هو النقاء، ومعاينته تتوجّب أن نصل إلى هذه الحالة.
لا يجب أن يضع الإنسان، في مسيرة الجهاد، معاينة الله هدفًا له، وإلّا أضلَّه الشّيطان. من أراد أن يجاهد من أجل الرؤى والعجائب تُضلّله الشياطين. الله يُعطينا هذه النعمة منه، نحن نجاهد بالرّغم من معرفتنا أنّنا غير مستحقّين لهذه النعمة. يعرف المسيحي المجاهد أنه يستحقّ الجحيم، ولا يستحقّ أن يعاين الله، بسبب خطايانا لا نستحقّ هذه المعاينة. نحن كالإبن الشّاطر الذي عاد إلى أبيه قائلًا: "لست مستحقًا بعد أن أدعى لك ابنًا. إجعلني كأحد أجرائك"(لو15: 19). عندما يرى الله تواضع الإنسان وتوبته، وأن معاينته له لن توقعه في العُجُبِ والتكبّر، يسمح بذلك. نعرف العديد من القدّيسين في كنيستنا عاينوا الله وهم أحياء. عدم معاينة الله في حياتنا لا تعني أنّه غير موجود، بل علينا أن نقول إنّنا غير أنقياء وغير مستحقّين لهذه النعمة.
المسيحيّة ليست نظامًا ايديولوجيًا، ولا فلسفيًا، بل هي الطريق التي توصلنا إلى الله. معاينة الله لا تكون معاينة لجوهره إنما لنوره، أي قواه ومجده. هذا هو النور الذي عاينه الرّسل عندما تجلّى الرّب أمامهم. نحن مدعوّين لمعاينته، وإن لم نكن مستحقين لذلك في هذا الدهر، علينا أن نجاهد لنستحق تلك المشاهدة في الدّهر الآتي.
تُعطى البركة للإنسان أثناء الصلاة. يعلّمنا الآباء القدّيسون أنه في الصلاة تكون كل قوى الذهن متّجهةً نحو الله، بهذا نتعلّم أن نصلّي بدون تشتّت. الإنسان الذي يصلّي بتشتّت لن يقدر أن يعاين شيئًا من الله، بل عليه أن يحصر ذهنه مع الله. وإذا رأى الله أن هذا الإنسان مستحقّ، يمكن أن يسبغ عليه شيئًا من نعمته. يتّجه كلّ ذهننا عند الصلاة نحو الله، حينها يتّجه الله إلينا. يقول القدّيس إسحق السّرياني: "إن وقت الصلاة هو الوقت المؤاتي لفيض الرّضى الإلهي، إذ تحصر النّفس ذاتها في همّ واحد فقط"، هذا الهمّ هو يسوع المسيح.
وصول الإنسان إلى هذه الحالة الرّوحيّة لا يعني أنّه لن يتعرّض للتجارب، لكن ذهنه الذي اقتنى هذه النعمة يُصبح محصّنًا، ولا يُمكن أن يُخترقَ بسهولةٍ. هكذا ينمو الإنسان ليستطيع أن يكون دائمًا مع الرَّب، كما يقول القدّيس بولس الرّسول: "نكون كلّ حينٍ مع الرَّب"(1 تس 4: 17)، وهكذا يكون معه في الدّهر الآتي أيضًا.
آخر المواضيع
كلمة قدس الأرشمندريت غريغوريوس اسطفان في صلاة الغفران
الفئة : عظات اﻷرشمندريت غريغوريوس اسطفان
إدانة الخطأ وإدانة الخطأة
الفئة : عظات اﻷرشمندريت غريغوريوس اسطفان
غاية الحياة المسيحيّة ومعرفة الله
الفئة : عظات اﻷرشمندريت غريغوريوس اسطفان
النشرات الإخبارية
اشترك الآن للحصول على كل المواد الجديدة الى بريدك الالكتروني